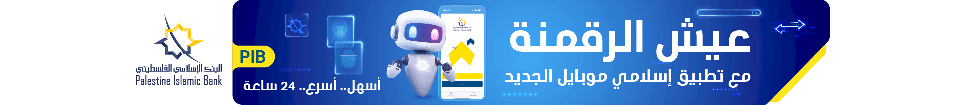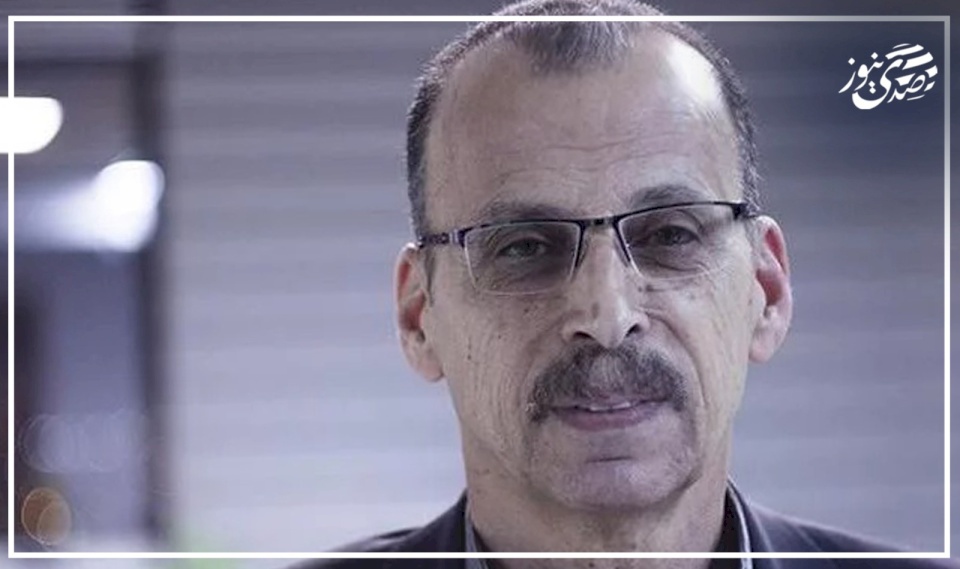
تأمّلات في معنى الوجود في ظلّ التوحّش
في زمن الأزمات الإنسانية الكبرى، تنشأ أسئلة وتساؤلات وشكوك حول جدوى الحياة، التي تجتاح الأفراد والجماعات، وتصبح ثقيلة وشديدة الوقع مع تعذر الخلاص، وغياب المنقذ.
إن سؤال المعنى، أو السؤال عن معنى الوجود، ينزل ثقيلًا وضاغطًا على الأفراد والجماعات في زمن هذه الأزمات والكوارث، سواء التي يسببها البشر أو التي تصنعها الطبيعة. ومنذ القدم بحث الإنسان عن معنى لهذا الوجود، ووجده بالإيمان بآلهة وبإعمار الأرض وتحقيق ذاته، ولاحقًا وجد الله الواحد، وتعرف عليه من خلال الأنبياء المرسلين، فشعر بالسكينة والطمأنينة، فتراجع القلق الوجودي، ومنها نشأت أنظمة وضوابط سلوكية وأخلاقية، حدت من تغول الإنسان على أخيه. ولكن انتقال البشرية إلى عصر الحداثة لم يمنع ظهور الأزمات والحروب والتوحش واستغلال الإنسان والأوبئة، مما يعيد طرح الأسئلة ذات الطابع الوجودي، ومن ناحية أخرى، ويدفع أصحاب الخبرة وذوي الضمائر الحية لشحذ العقل مجددًا وابتكار طرق أخرى لمجابهة العنف والشر المطلق.
في زحمة الحياة وهمومها، يغفل الناس هذا السؤال الوجودي، إذ يستسلم بعضهم للقدر ولروتين الحياة، وبعضهم لا تتيح لهم هموم الحياة وحاجاتها اللانهائية، الضرورية والكمالية، الانشغال في هذا السؤال. وهو سؤال شغل، وينشغل فيه، عادة، مفكرون وفلاسفة، أو روائيون من ذوي النزعة الفلسفية، ومنهم من وضع نظريات حول الوجودية، أو روايات دستوبية (سوداوية)، ليس فقط في زمن العصور القديمة والوسطى، بل أيضًا في العصور الحديثة. ففي العصور الحديثة، بعد أن استقبلت النهضة الأوروبية الإصلاح الديني والثورة الصناعية والسياسية بحفاوة وبآمال عريضة، عادت التناقضات الداخلية أكثر حدة، واشتعلت والحروب البينية، العالمية- الأولى والثانية في بلاد الحداثة، التي أفضت إلى إبادة ملايين البشر الأوروبيين، مما أحدث هزة عميقة في منجزات الحداثة. بل قبل ذلك، ومع بداية تحول البرجوازية إلى طبقات رأسمالية واستعمارية، خاصة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وظهور فجوات اجتماعية داخلية عميقة، مترافقة مع توسع بؤس طبقة العمال والأجيرين، نشأت كتابات تأملية وفلسفية عن معنى الحياة وهدف الوجود، إلى جانب كتابات وتنظيرات عن كيفية تغيير هذا الواقع؛ بالإصلاح أو بالثورة. وقد فاقمت الإخفاقات والنكسات والمصائب التي سبقت استقرار الأنظمة الديمقراطية، الشعور باليأس، والكفر بالحياة. رفض اليساريون والاشتراكيون الانشغال بهذا السؤال، وركزوا برامجهم ونشاطهم على عملية التحرر الجماعية من أنظمة الاستغلال والاستبداد. بل بعضهم ذهب إلى اعتبار الفلسفات الوجودية تفكيرًا مثاليًا لا يؤتي نتيجة، أو مضيعة للوقت.
يحظى غالبية المتدينين، وخاصة المؤمنين منهم، بحصانة عالية، ضد هذا السؤال أو ما يترتب عليه من شكوك في عقيدتهم التي توفر للمؤمن معنى وملاذًا، وتمنع الانهيار الداخلي والاستسلام. وينطبق هذا الأمر أيضًا على أصحاب الرسائل الإنسانية أو التحررية، من العلمانيين وغير الدينيين، الذين أبدى، ويبدي الكثير منهم استعدادًا وجهوزية فعلية ونفسية للنضال ودفع الثمن من أجل هدف نبيل. وتتفاوت قدرة البشر على التماسك والصمود في وجه الانهيار الداخلي، ونجد بعضًا منهم، كثيرًا أو قليلًا، قد جرفتهم دوامة هذا السؤال، بعد نفاذ مخزون المناعة الداخلية، وهذا أمر طبيعي وإنساني. وليس غريبًا أن تجد من أهالي غزة، ومنهم متدينون، يسألون، تحت وطأة هذا الإفناء والمحو الجسدي، وبعد كل هذا الخذلان العربي والإسلامي والعالمي: أين الله!. وقرأنا على وسائل التواصل الاجتماعي نقاشات بهذا الخصوص، وقرأنا ردودًا لأناس متدينين، ذوي ثقافة دينية واسعة، يردون على متدينين آخرين، وينشرون مواقف تحثهم على التمسك بالإيمان، بعضها كانت قاسية وأخرى كانت متفهمة. ولكن يمكن القول إن صمود غالبية الغزيين، في وجه جريمة إبادة جماعية غير مسبوقة في وحشيتها، ما كان ليتحقق لولا هذا الإيمان الديني والوطني والإنساني الراسخ، الذي يوصف بالأسطورة.
في هذا العصر، قد لا نجد شعبًا بهذا القدرة على التحمل كشعب فلسطين، مع أن الكثير من الذين يكتوون بحرب الإبادة يتحفظون على انطباق ذلك على كل الشعب الفلسطيني، بسبب غياب التفاعل الشعبي الحقيقي والفاعل، وضعف الفعل التضامني، من مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني.
مرت على الشعب الفلسطيني محن رهيبة كثيرة، والتي أفنت أجيالًا منه، في خضم مواجهة حروب إسرائيل العدوانية، أو استبداد وإجرام أنظمة عربية ضد شعوبها وضد الشعب الفلسطيني. وأنتجت هذه المحن وهذه المواجهة الممتدة مع المشروع الاستعماري الصهيوني الإبادي، أدبيات كثيرة تعنى بالسؤال عن مسببات الهزائم المتكررة، وكيفية تفاديها، ومنها ما هو مهم وجذري، ومنها ما هو عام وشعاراتي وتعبوي ومفتقد للعمق والشمولية، ولكن تلك الأعمال النقدية الجذرية النوعية ظلت قاصرة عن التحول إلى خطة إستراتيجية.
ولكن السؤال الوجودي لم يطرح، أو يحضر، بالحدة كما يطرح اليوم لدى شعوب العالم عامة، وفي أوساط فلسطينيين بصورة خاصة. فالحرب ماكنة تلتهم البشر والحجر، وتصنع قصصًا ومآسي، ويضمحل أمامها الوجود الإنساني، بحيث لا يبقى في نظر الكثير من الناس أي هدف يستحق العيش من أجله. نحن اليوم في حالة حرب غير مسبوقة في وحشيتها، إذ إن من ينفذها هي أكبر قوة عسكرية على الأرض، هي الإمبراطورية الأمريكية وحلفاؤها، ضد أصغر كيان على الأرض، وأشد الناس فقرًا وعوزًا، وتنفذ بوحشية تفوق الوصف، عبر البث الحي، وبطريقة سادية صارخة، يوثق فيها القتلة أنفسهم وهم مستمتعون بتفجير البيوت وإبادة الأطفال والنساء والكبار، دون أدنى وازع أخلاقي أو إنساني. إزاء حرب همجية من هذا النوع، وفي هذا العصر، القرن الواحد والعشرون، يقف الإنسان المقهور، والحر، ليس في فلسطين فحسب، بل في أرجاء الكون، مصدومًا ومصعوقًا، متسائلًا كيف يمكن لكل هذا أن يحصل دون عقاب، ودون أن يأتي منجد، كيف يمكن أن لا يتعظ الإنسان، أو الذين يتسيدون الدول، من دروس التاريخ!
ربما هذه الصدمة الكبرى لدى شعوب العالم وقواه التقدمية والإنسانية، وهذا الشعور بالرعب من طبيعة النظام العالمي القاتل، وقاعدته الصهيونية، هو بالضبط ما حفز تشكيل جبهة عالمية مدنية مناضلة، مجسدة تقاطعية نضالية استثنائية في عمقها واتساعها، ونمو وعي كوني بضرورة إنقاذ البشرية من أنياب البرابرة الجدد. ومثلما تغلبت الشعوب في الماضي على مآسيها أو خففتها، تؤمن الأجيال الجديدة بالقدرة ذات الحس المرهف بالظلم، على المضي في مسيرة استعادة الإنسان، ومصرة على محاصرة وعزل ومعاقبة القتلة. ففي مقابل إنسان لا يتعظ من التاريخ، ولا يرتدع عن ارتكاب الفظائع، هناك إنسان مصر على عدم التخلي عن إنسانيته وأخلاقياته، وعلى هدفه النبيل في التخفيف من آلام الحياة.
بهذا المعنى يتحدى شعب فلسطين، والحركات الشعبية العالمية الفراغ الوجودي، من خلال بلورة رؤية كونية تحررية في مواجهة الهمجية.

صمتوا دهراً و نطقوا كفرا

هذا هو الواقع، فماذا نحن فاعلون؟

ترامب وزبانيته من المهاجرين

كرّر كلمة "النصر" 654 مرّة وحقّقه على الجبهات الأخرى وعَلِق في غزّة...

مذبحة غزة لن تنقذ إسرائيل من نفسها

الاحتجاجات في غزة: بين صرخة المعاناة وحسابات المرحلة

رحيل الحوراني، زقطان و"الحوت": صمت لا يُشبههم