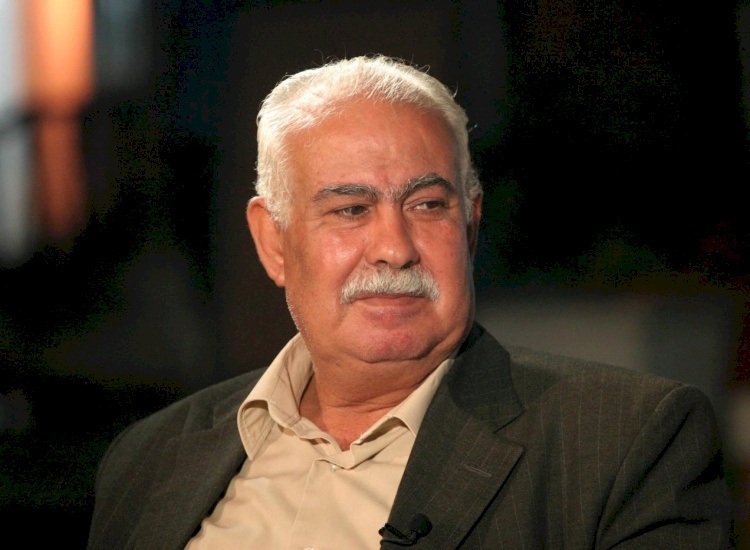
بـعـيـداً عـن الـبـكـائـيـات
ليس مهماً كم من العقود مرّت على ذكرى هزيمة حزيران، ولا على غيرها من النكبات والانتكاسات والمحطات المؤلمة التي عايشها الشعب الفلسطيني، منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948. في كثير من الأحيان كانت القراءات لتلك الهزيمة، تتسم بالبكائية والندب، أو توزيع المسؤولية عنها على العرب أو على القوى الاستعمارية التي قدمت الدعم لإسرائيل.
ربما يعتقد البعض أن العودة لقراءة مدى أهمية وخطورة تلك المحطة، لا تنطوي على أي قيمة عملية، غير أن ما جاءت به الأحداث والتحولات اللاحقة تشير إلى غير ذلك. السؤال المفتاحي هو: هل كانت القوى الاستعمارية التي دعمت المشروع الصهيوني، ووفرت له كل أسباب النجاح، ستسمح للعرب بأن يدمروا ذلك المشروع ذا الأبعاد الإستراتيجية؟ كان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر صادقاً جداً في مشروعه القومي التحرري، لكن التزامه وصدقه إزاء هذا المشروع، يفتقر إلى دقة الحسابات، ليس فيما يتصل بقدرة مصر والعرب على تحقيق ذلك، وإنما بما له علاقة بالتوازنات الدولية.
من المشكوك فيه تماماً أن يكون الدعم السوفياتي لنظام عبد الناصر، كان يصل إلى مستوى القناعة بضرورة تدمير إسرائيل. الاتحاد السوفياتي كان من أوائل الدول التي اعترفت بإسرائيل بعد قيامها، ويدرك، أيضاً، أن الوصول إلى هدف تدمير المشروع الاستعماري، ربما كان سيؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة ما كان ليسمح لنفسه بأن يكون المسؤول عن اندلاعها. عدا ذلك ربما كان على قيادة الحزب الشيوعي السوفياتي أن تتواطأ مع طريقة تفكير الرأسمالية إزاء معالجة ما تسمى الأزمة اليهودية، فلقد فشلت عملياً رؤية لينين لمعالجة تلك المسألة، التي عانت منها الدول الاشتراكية، أيضاً وليس فقط الرأسمالية. إذا كان ذلك صحيحاً، فإنه يعني أن عبد الناصر، قد دخل المعركة مع إسرائيل مكشوف الظهر، وأن ما حصل عليه من دعم سوفياتي، ليس إلاّ ترجمة لإستراتيجية سوفياتية في إطار الصراع بين المعسكرَين الاشتراكي والرأسمالي لا تصل إلى مستوى تدمير إسرائيل، الأمر الذي كان سيؤدي إلى صدام كبير وخطير.
من بين ما يمكن استخلاصه هو أن المشروع الصهيوني مشروع دولي أساساً إذ لم تكن الحركة الصهيونية قادرة على هزيمة الفلسطينيين والعرب، وتحقيق حلم الدولة لو لم تكن مستندة إلى الدعم الحاسم من قبل الاستعمار البريطاني والفرنسي.
هذا الاستخلاص عملياً يعني أن هزيمة هذا المشروع تحتاج إلى تغيير كبير في توازنات وظروف الأوضاع الدولية، من دون أن نتجاهل دور الفلسطينيين والعرب في الكفاح على أرض الواقع وعلى المستوى الدولي. ثمة قيمة كبيرة للنضال الفلسطيني الذي يستهدف توعية المجتمع الدولي بمدى خطورة إسرائيل كمشروع استعماري عنصري، وبأن حل المسألة اليهودية بالطريقة التي اختارتها الدول الاستعمارية، إنما يخلق أزمة أشدّ خطورة، حين ينشأ عن ذلك أزمة فلسطينية ذات عمق قومي عربي، لا تعبر عنه بالضرورة الأنظمة السياسية العربية، وإنما تعبر عنه مئات ملايين العرب.
لعل من أبرز النتائج السلبية لتلك الهزيمة هو التراجع الكبير للمشروع القومي العربي، بما أنه مشروع وحدوي تحرري، كما طرحه عبد الناصر. بالإضافة إلى ذلك، ما أسفرت عنه وقائع الصراع لاحقاً لهزيمة حزيران، ومن بين أهمها خروج الجيوش العربية من دائرة المراهنة على خوض الصراع، وتغير حسابات النظام الرسمي العربي، باتجاه التعامل حتى الخضوع لسياسة الولايات المتحدة، انطلاقاً من قناعة عبّر عنها الرئيس الراحل أنور السادات الذي أطلق جملته المشهودة: «إن 99% من الحل بيد أميركا». أما ما يمكن إضافته على طبيعة الصراع من أساساته، هو ما نجم عن ذلك، من تكريس لفكرة أن إسرائيل أصبحت معرفاً بها على الأرض التي احتلتها عام 1948 وأن الادعاءات الفلسطينية والعربية، محصورة في الأراضي التي احتلها بعد هزيمة حزيران.
حين وافق الفلسطينيون على اتفاقية أوسلو، وقبلهم وافقت مصر على اتفاقية كامب ديفيد، انفتح الطريق أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ مئات القرارات التي تؤكد حصر الحقوق الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة والقدس، من دون أن يتمكن أحد من امتلاك القوة، حتى لإرغام إسرائيل على الاعتراف بذلك.
في الواقع، إن إسرائيل هي السبب والعامل الرئيسي الذي يدفع باتجاه تصحيح تلك الخطيئة، حيث إن سياساتها وأطماعها التوسعية تدفع الصراع نحو جذوره بما أنه صراع شامل على كل الحقوق وكل الأرض. هذا ليس مهماً بالنسبة للفلسطينيين فقط، وإنما سيدرك العرب المتهافتون على التطبيع مع إسرائيل، أن مشروعها يشكل خطورة حقيقية عليهم، إلى أن يصحوا إلى حقيقة أنهم أُكلوا يوم أُكل الثور الأبيض.
هذا ليس كل شيء يمكن استخلاصه، ولكن المقام لا يتسع للمزيد، والصواب يقتضي الاعتراف بمدى أهمية العمل الفلسطيني على المستوى الدولي، وأهمية العمل على تعميق التناقضات في إسرائيل، وفضح سياساتها العنصرية والتوسعية.

حركة حماس وإشكالية السلاح

"الدولة الفلسطينية" أداة تطبيع الأبرتهايد والإبادة!

حول خطبة نتنياهو...

نداء من فلسطين لا تضطهدوا المسيح في أرض الرسالات

إسرائيل 2030: بين بقرات مذبوحة ولعنة الإبادة

المطلوب من المجلس المركزي الفلسطيني

نصيحة من نبض الشارع إلى القيادة الفلسطينية الانقلاب الأبيض خطرٌ ناعم على قضيتنا







