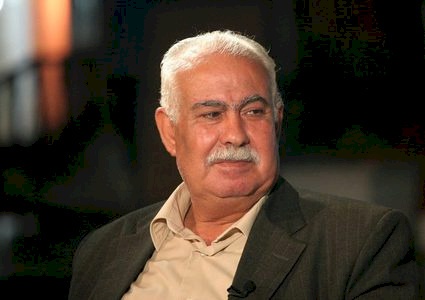
التصدي مسؤولية جماعية وفردية
تقول آراء، متخصصين، ومراقبين، ونشطاء، وحتى بسطاء من العامة إن السيدة المتوحشة «كورونا»، هي من إنتاج أحد المختبرات في إحدى الدول المتقدمة جداً.
وقال كثيرون، إن نشر هذه السيدة في مختلف أرجاء الأرض، ليس سوى فصل من فصول حرب بيولوجية، موجهة لاقتصاديات الدول، بما فيها مجمع العشرين دوله الأغنى في العالم، وهدفها إعادة عجلة تاريخ القوة إلى ما قبل مرحلة التنافس الصيني الأميركي حيث السيطرة شبه المطلقة للولايات المتحدة على النظام العالمي.
بعض المختصين قدموا وثائق تؤكد هذا الاستنتاج، لكن الفاعل لم يعترف بجريمته، ولكن أصابع الاتهام موجهة نحو الولايات المتحدة، والصين، هذا بالنسبة لبعض المرتجفين الذين لا يريدون لأسباب مختلفة، الاعتراف بأن الولايات المتحدة، هي الطرف الأكثر ترشيحاً.
لا يعود سبب هذا الترجيح، إلى الاستنتاج العميق، سواء كان أيديولوجياً أو سياسياً، بأن الولايات المتحدة هي الدولة الاستعمارية الأكبر والأكثر عدوانية.
يضاف إلى ذلك، أن الرئيس المهزوم دونالد ترامب، قد اتسمت السنوات الأربع التي قضاها على رأس الإدارة الأميركية، بالعدوانية الشاملة، ذلك أنه وظف كل إمكانيات الولايات المتحدة، لشن حروب تجارية، واقتصادية، ولوجستية واستخباراتية وحربية، طالت الأمم المتحدة، وحتى حلفاء أميركا التاريخيين في أوروبا، وما بين هذه وتلك من الدول. في الواقع فإن عديد المختبرات في العالم، قد اشتغلت على فك شيفرة الفيروس، ولتصنيع اللقاح المضاد له، وقد برزت في هذا الإطار الصين، روسيا، انجلترا وألمانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة، ربما لهذا السبب، كان على المختبرات الأميركية أن تسارع في توفير اللقاح، الذي يعتبره ترامب جزءاً من أمجاد إدارته.
السنوات القادمة ستكشف طبيعة هذه الحرب، وأسرارها والمسؤول عنها، إنما يجب الاعتراف أولاً، بأنها حرب بيولوجية، وإنها تسببت بانهيارات اقتصادية في عديد الدول، وبصعوبات هائلة في دول أخرى.
ولعل الكثيرين يشيرون أيضا إلى أن فئة كبار السن، وهم غالبا متقاعدون يحملون الدول الرأسمالية ميزانيات وأعباء ضخمة، هم أيضاً مستهدفون بما يخفف عن تلك الدول مليارات الدولارات، ويشكل بالإضافة إلى ذلك عبئاً على المنظومات الصحية في تلك الدول.
الفلسطينيون الذين بالكاد، يستطيعون النهوض اقتصاديا بمسؤولياتهم تجاه المجتمع في ظل سياسة الإفقار التي تتبعها إسرائيل والضغوط التي يمارسها الممولون، يعانون من الآثار الكارثية، التي يتسبب بها انتشار الفيروس.
بعيداً عن الاستنتاجات التي تصدر من هنا وهناك حول حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني في الضفة وغزة، فإن من يعيش على الأرض في هذا الجزء من فلسطين، يدرك أن هذا الفيروس قد تسبب بشلل، في كثير بل معظم القطاعات الاقتصادية والتجارية.
قبل بضعة أشهر، كان نشطاء التواصل الاجتماعي يتندرون حول خلو قطاع غزة من الفيروس، وبعضهم كتب تغريدة تقول: «إن ترامب قرر أن ينقل إدارته إلى غزة، بسبب نظافتها من الجائحة»، ولكن ما كان لذلك الوضع أن يستمر، إذ انتقلت العدوى وأصبح قطاع غزة، واحداً من البيئات الأشد خطورة.
الفيروس بات يتجول في كل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس، فأعداد الوفيات في ازدياد وكذلك أعداد المصابين والمخالطين.
ربما كانت نسب الوفيات، عادية، بمعنى أنها لا ترتفع إلى الحدود غير الطبيعية، ولكن ذلك ليس مدعاة، للاطمئنان، والاستهتار والاقتداء بالسويد، التي اعتمدت سياسة مناعة القطيع منذ البداية، فالظروف الاجتماعية والجغرافية والمناخية والإمكانيات تختلف جذرياً.
ثمة اكتظاظ سكاني خلال بقعة جغرافية محدودة، وثمة عادات، وتقاليد اجتماعية عميقة، تتسم بالحميمية، والتماسك العائلي والاجتماعي ولكن ثمة استهتاراً أيضاً.
الفلسطيني هو أغلى شيء، ذلك أن قيمته تفوق قيمة الأرض، وتفوق قيمة الاقتصاد، ولذلك، وجب على السلطات أن تقدم سلامته على كل ما سوى ذلك. في الحقيقة، فإن ثمة اهتماما من قبل السلطتين في الضفة وغزة، وتتعاون أجهزة مختلفة في محاولة الحد من انتشار الفيروس وضمان سلامة الناس.
لكننا نتحدث عن سلطتين، وخطتين، ومسميات متشابهة لكن كلا منها على حدة، وأجهزة أمنية، وشرطية، وطبية مختلفة، إنه حال الانقسام الفلسطيني، الذي يضرب فيروسه، في مساحات المجتمع الفلسطيني.
ثمة لجنتا طوارئ في الضفة وغزة، ولكنها لجان رسمية سلطوية، لا تشمل مكونات المجتمع الفلسطيني سواء كانت فصائل أو مؤسسات طبية خاصة وأهلية، أو مجتمعا مدنيا.
الحال أن مواجهة هذه الحرب تقتضي تجنيد كل الإمكانيات الوطنية والاجتماعية، على الأقل، كمؤشر على القناعة ببناء الشراكات.
نحتاج إلى لجنة طوارئ وطنية واحدة، تشمل الجميع، هذا على المستوى الرسمي. على أن المواطن، يتحمل جزءاً أساسياً من المسؤولية، توخياً لسلامته، وسلامة عائلته وأقاربه وجيرانه.
ثمة استهتار يقتضي الصرامة في مواجهته إذ إن كثيرا من الناس، يتجولون من دون الحد الأدنى من إجراءات السلامة، وهو ارتداء الكمامة على الأقل.
إن كانت الإجراءات المعلنة من قبل السلطات لصالح الناس، بمثابة قوانين، فإن القوانين تفرض بالقوة ولكن ليس بالقمع والقمع المسيس بالإضافة إلى حملات توعية مكثفة بحيث تصبح الإجراءات جزءا من حياة الناس، إلى أن يزول هذا الكرب.
الأصل هو أن كل إنسان مسؤول شخصياً عن سلامته، وسلامة من حوله وأن على كل الفلسطينيين خوض هذه الحرب والانتصار فيها، لأن الشعب الفلسطيني فيه ما يكفيه من المصائب والأزمات، وأن سلامة الناس، تعني تعزيز الصمود من أجل انتزاع الأرض والحقوق.














