
الواقع ليس قدراً لا يمكن ردّه
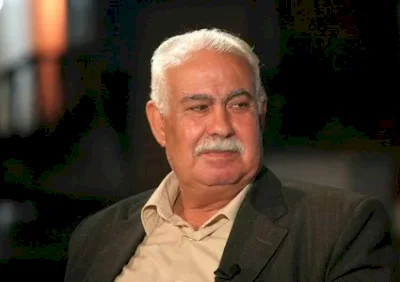
قد يعتقد البعض أن الحديث عن مراجعة وتقييم المرحلة السابقة، إنما هو تكرار لنداءات سبقت، أو حتى مراجعات من قبل بعض الكتّاب والمؤسّسات، وربما هناك من يعتقد أن ذلك ليس أكثر من هروب من معالجة وقائع الأحداث والصراعات اليومية.
ليس الأمر كذلك، وإنما هي محاولة للبحث في الجزء الممتلئ من الكأس، وفحص إمكانية وجود مربعات للعمل الفلسطيني في ظل الواقع القائم، وفتح بوابات، أو حتى فتحات صغيرة لإنعاش الأمل، في ظل حالة التيه والإحباط السائدة.
خلال العقود السابقة سيطر على الوضع الفلسطيني خطابان حكما السياسات والمواقف والممارسات، ويرسمان مشهداً بائساً لأداء السياسة الفلسطينية، الأول، خطاب أوسلو؛ الذي شكل حالة استقطاب فصائلي حكم المواقف إزاء كل ما نجم عن ذلك الاتفاق. الخطاب الثاني، خطاب الانقسام والمصالحة والوحدة الوطنية، بما ينطوي عليه من تداعيات على مختلف المستويات، الوطنية والخارجية، وبمضامين متناقضة في الجوهر، وتبريرية في المظهر. الكل يدعو للوحدة، ويتطلع لإنهاء الانقسام على طريقته ووفق حساباته الذاتية. لكن المحصلة صفر كبير، فيما يتكرس الانقسام، ويتخذ أبعاداً مؤسّساتية مأساوية. السبب في استمرار وتفاقم الوضع القائم على الانقسام، يعود إلى تغيير موازين القوى الداخلي بين الفصائل، ما يستدعي تغييرات جذرية واسعة وعميقة في النظام السياسي، من حيث البنية، وآليات اتخاذ القرارات، وإقرار السياسات، والاستراتيجيات، وذلك أمر دونه عناد شديد، وغياب الاستعداد لتقديم التنازلات، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية. في الأصل، فإن وقوع الانقسام كما نعرفه، اليوم، قد وقع بفعل حسابات سياسية، وفئوية، من قبل حركتي فتح وحماس، واستند إلى فعل إسرائيلي خبيث ساعد في وقوع الانقسام، حين اتخذ شارون ونفذ قراره بإعادة تدوير زوايا الاحتلال لغزة، وسحب قواته إلى خارجها، ودمر الوجود الاستيطاني فيها، كان يستهدف إدخال القوى السياسية الفلسطينية في حالة صراع، بما يخلق بيئة مناسبة لوقوع الانقسام على النحو الذي حصل. الحسابات كانت تشير إلى أن حركة حماس ستتفوق على حركة فتح في الانتخابات التي جاءت بعد ذلك العام 2006، ولذلك سهّلت إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس حينذاك. الرئيس جرى انتخابه العام 2005، وهو من حركة فتح، والمجلس التشريعي بعد ذلك أصبح خاضعا للأغلبية التي حصلت عليها حركة حماس. كيف يمكن إدارة السياسة الفلسطينية في مثل هذه الحالة، خصوصاً في ضوء التزام الطرفين بسياسات واستراتيجيات متناقضة ومتصارعة؟ كان بإمكان السلطة أن تدافع عن وجودها وسلطتها في قطاع غزة، فلقد كانت تمتلك من الإمكانيات ما يفوق كثيراً ما تحوز عليه حركة حماس، هذا فضلاً عن أن حركة فتح الكبيرة لم تدخل ميدان الصراع على السلطة. على الأرجح أن الحسابات ما كانت تتوقع بقاء «حماس» في السلطة، ذلك أنها يمكن أو يفترض أن تنهار أمام ثقل المسؤولية عن إدارة مليوني فلسطيني في غزة في ظل ظروف غير مواتية.
حماس من جهتها اعتبرت أنها أمام فرصة تاريخية لإقامة سلطة ترتكز عليها في صراعها من أجل السيطرة على المؤسسة والقرار الفلسطيني وهي في الأساس، ليست لديها مشكلة، بل إنها تسعى لإقامة سلطتها على أي جزء من أرض فلسطين وأن تنافس بعد ذلك على الشرعية وأن تفرض نفسها بقوة الأمر الواقع على جميع الأطراف.
كان ذلك قد وقع قبل اندلاع ما يسمى الربيع العربي، الذي حمل مستقبلاً واعداً لجماعة الإخوان المسلمين وللإسلام السياسي عموماً، ما شكل في الخلفية محفزاً قوياً لحركة حماس. وفي الاتجاه المعاكس شكل ذلك حافزاً قوياً لحركة فتح والسلطة، في ظل وفاة شارون، وتسلم إيهود أولمرت رئاسة الحكومة، وفي ظل استمرار نشاط الرباعية الدولية في الدفع نحو مفاوضات سياسية لتجاوز العقبات التي اعترضت بقوة اتفاقية أوسلو.
فشلت الحسابات على جانبي عملية الانقسام، ففي حين انتكست محاولات إحياء التسوية، فإن جماعة الإخوان المسلمين، والإسلام السياسي في المنطقة عموماً شهد هزائم وانتكاسات خطيرة ما ترك «حماس» دون ظهير عربي وإسلامي قوي. في الحقيقة فإن الحركتين لم تدركا مدى قوة الفاعل الإسرائيلي، الذي اشتغل كل الوقت على سياسات إبقاء الانقسام، والفصل بين الضفة وغزة، وإبقاء «حماس» في غزة، وفتح في الضفة، انطلاقاً من سياسات تتخذ من موضوع الانقسام ذريعة، بالإضافة إلى ذرائع أخرى، لتعطيل المساعي الدولية، والإقليمية لإحياء عملية السلام على أساس رؤية الدولتين.
الخطاب والسلوك الفلسطيني بمجمله أصبح محكوماً لهذه الوقائع حيث عملية سياسية معطلة، وعملية تجريف للحقوق الفلسطينية، ومساعٍ غير موفقة لتحقيق المصالح واستعادة الوحدة بالرغم من طول الفترة وتدخل وساطات عربية قوية، وأخرى دولية وإقليمية محدودة.
شمعون بيريس كان قد اعتبر الانقسام ثالث إنجاز تاريخي للحركة الصهيونية بعد الإنجاز الأول إقامة الدولة العام 1948، وهزيمة حزيران العام 1967، فهل صحيح أن الانقسام على هذه الدرجة من الخطورة؟ كثير من الفلسطينيين اعتبروا الانقسام نكبة بخطورة نكبة 1948، أم أن ثمة مبالغة شديدة في ذلك؟ إذا كان الانقسام مع إدراكنا والجميع للآثار الخطيرة التي ترتبت عنه يوازي أو يقترب من خطورة النكبة، فإن ذلك يعني أن لا أمل إطلاقاً في إنهائه واستعادة الوحدة، وأن المشهد كله أسود لا ينطوي أو يتيح أي فرصة لرؤية مزايا ولو بسيطة لاستثمار ما يمكن أن يتيحه الواقع لصالح الفلسطينيين.
هنا مربط الفرس، فبالرغم من استمرار أوسلو بكل تداعياته وفي ضوء سياسة التجريف الإسرائيلية وبالرغم من استمرار وتعمق الانقسام لا بد من رؤية الفرص المتاحة والتعامل معها، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً على الأفق بالنسبة للانقسام. دخول الجزائر على الخط بالإضافة إلى الجهد المصري الذي لا يتوقف عن المحاولة لإنهاء الانقسام يشكل عاملاً إيجابياً إضافياً، ولكن هل يمكن لهذا العامل أن ينجح فيما فشلت في تحقيقه المحاولات السابقة؟
المؤشرات على النجاح سواء في الجهد الجزائري أو في التوجه نحو عقد اجتماع ينطوي على جدية مختلفة للمجلس المركزي، هذه المؤشرات ضعيفة، ولذلك ينبغي على الأقل، تحقيق توافق فلسطيني على مهمة كبرى وأساسية وهي تعزيز صمود المواطن على الأرض، وتحقيق تكامل في الأدوار المتبادلة لتعظيم النشاط الفلسطيني المثمر على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلاً عن تصعيد المقاومة الشعبية السلمية المتعاظمة في الضفة الغربية والقدس، هذا على أقل تقدير. ثمة حاجة لوقف سياسة الاستنزاف الداخلي والانتقال للمبادرات الإيجابية.