
إمّا أن ننجح أو ننجح
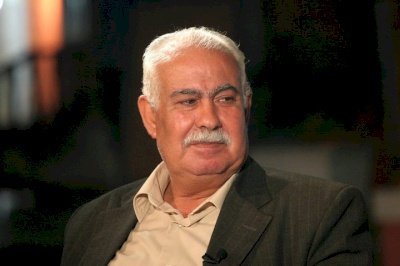
لا يبدو أن اجتماع الأمناء العامّين للفصائل، استحوذ على شعبية لافتة تقارب أهميته.
الإعلام الفلسطيني لم يكن فعّالاً، في نقل الرسائل التي صدرت عن الاجتماع، وبالتالي جاءت ردود الفعل باهتة نسبياً.
ثمة مبرر لدى الجماهير الفلسطينية، عدا انشغالها بجائحة "كورونا"، وبالأوضاع الاقتصادية المزرية، فلقد سبق لها أن صفّقت لعديد المشاهد الاحتفالية، لكنها في كل مرة أصيبت بخيبات أمل فلماذا يختلف الأمر هذه المرة؟
ثمة عوار في الخطاب السياسي والإعلامي الفلسطيني الذي يغلب عليه طابع الاتهامات، والتهديد، وانتقاد الآخرين، والمبالغات الشخصية في توصيف واقع الحال، بعد الإعلان عن "سلام إبراهيم"، واستمرار السياسة الأميركية، في لعب دور الوكيل الفاعل لتنفيذ المخططات الصهيونية، عبر تهديد عديد الدول العربية، لإرغامها على اتباع السلوك الإماراتي.
ينقص هذا الخطاب، إعادة صياغة الوطنية الفلسطينية وبثّ الأمل في نفوس الناس، بأنهم أصحاب قضية عادلة، وأنهم قادرون على هزيمة المشروع الصهيوني، ومن يتحالف معه، وأن اليقين بجانب الفلسطينيين من أنهم سيستعيدون كل حقوقهم التاريخية على كل أرض فلسطين التاريخية.
ثمة حاجة ماسّة إذاً لإعادة صياغة الخطاب السياسي الإعلامي الموجّه للشعب الفلسطيني أولاً، حتى لو أن القيادة السياسية لديها ما يبرر المناورة واعتماد خطاب الشرعية الدولية، والحق الفلسطيني على الأراضي المحتلة منذ العام 1967، وذلك لأغراض، سياسية تكتيكية، ولتوسيع دائرة التضامن مع الشعب الفلسطيني.
بالتأكيد فإن اجتماع الأمناء العامين جاء متأخراً، ومتأخراً كثيراً، إذ لا يمكن تبرير مثل هذا التأخير، طالما أن المؤشرات العملية والنظرية كانت منذ فترة ليست قصيرة تشير إلى الوجهة التي جعلت الاجتماع ممكناً في هذا الوقت.
لم يكن ثمة ما يبرر هذا التأخير المكلف، لو أن الفلسطينيين قرؤوا على نحو عميق ما تطرحه المؤسسات الإسرائيلية، وتتبعه بممارسة عملية، وما تتجه نحوه الأوضاع العربية من تدهور حتى الانهيار، في ظل إدارة أميركية لم تتأخر أو تتردد في إعلان عدائها للشعب الفلسطيني وحقوقه، ورفضها وقتالها للأمم المتحدة وقراراتها.
لقد طغت القراءات النفعية، والذاتية، والحسابات الفئوية على الحسابات الاستراتيجية، إلى أن أصبح لقاء من هذا المستوى ممكناً بعد أن وصلت الخيارات إلى طريق مسدود تماماً، أمام كل أصحاب المشاريع المتضاربة.
علينا أن نصدق هذه المرة، أن الفلسطينيين، لم يعد أمامهم من خيارات، إلاّ بالعودة إلى الذات، إلى بعضهم البعض، وإلى شعبهم، لإعادة ترتيب صفوفهم واستعادة قوتهم والتخلّي عن الحسابات والمكاسب الصغيرة والمؤقتة بينما القضية تخسر.
لقد خاضت الفصائل والقيادات الفلسطينية معاركها السياسية وغير السياسية، بمعزل عن بعضها البعض، وبمعزل عن الشعب سواء داخل الأرض المحتلة أو خارجها.
من يستطيع الادعاء بأنه اتبع سياسة تقوم على الاستفادة من كل طاقات الشعب، خصوصاً نصفه الموجود في مخيمات الشتات والمهاجر؟
أربعة عشر عاماً من الانقسام، والصراع والمهاترات، والتآكل، فرضت الوقائع نتائجها على الكل، ومن بينها أن لا أحد استطاع أو يستطيع إلغاء الآخر، أو تقزيمه أو تجاهل وجوده، ما يقضي بضرورة إعادة بناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية على أساس الشراكة، سواء من خلال الانتخابات أو عَبر توافق وطني.
هذا الإجماع الذي برز من خلال اجتماع الأمناء العامّين، اتسمّ بالواقعية السياسية، وبوعي لطبيعة برنامج القواسم المشتركة، مع احتفاظ كل طرف بالاستراتيجية التي يراها لفصيله.
الاجتماع أرسل أكثر من رسالة لكل من ينتظر من الفلسطينيين جواباً عن أسئلة الواقع، ربما لم تصل بعد وبالجدية اللازمة لأي من هذه الأطراف بما في ذلك حتى للشعب الفلسطيني، ولكن ذلك لا يقلل من أهمية ما تم الاتفاق عليه.
الفلسطينيون لم يعودوا بحاجة إلى وساطات، والتعرض لضغوط، أو محاولات إقناع بشأن موضوع إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة.
منذ البداية كان الأمر هكذا لكن الحسابات الفئوية والمراهنات الوهمية، هي من جعل ملف المصالحة وكأنه ملف مغلق لا سبيل لمعالجته، رغم كثرة الاتفاقيات.
الاجتماع أعطى خمسة أسابيع كمهلة زمنية لإنجاز هذا الملف، ويُقال إن الحوارات قد بدأت بهذا الخصوص.
إن من يعتقد أن هذه المهلة قصيرة، ولا تدلّ على جدية القرار، عليه أن يقتنع بأن الأهمّ هو توفر الإرادة، فالحوارات لن تبدأ من الصفر، فثمة عديد التوافقات السابقة التي يمكن العودة إليها واعتمادها والبناء عليها.
في ظل توفر الإرادة، تغيب أسئلة كثيرة كانت مطروحة وتشكك في إمكانية عودة السلطة إلى قطاع غزة، في ظل جيوش المقاومة، ووجود سلطة، تتمسك بها حركة "حماس".
ثمة صيغ إبداعية يمكن أن تجعل الفلسطينيين أمام سلطة واحدة وقانون واحد، من دون إزاحات كاملة لما هو موجود على أرض الواقع، وأصبح من غير الواقعي تجاهله أو استسهال التعامل معه.
ربما كان ملف منظمة التحرير هو الأصعب من بين الملفات التي تم التوافق على معالجتها، ولكن إعادة بناء وتطوير وتفعيل المنظمة وإعادة الحيوية لأذرعها لم تعد مهمة مستحيلة، إذا طغى الوطني على الفصائلي، وإذا أبدت القيادات استعداداً لتقديم تنازلات لصالح العام الوطني. الآن يمكن التأكيد على أن الانتخابات العامة ممكنة وضرورية، رغم أنف الاحتلال.
هذه معركة ينبغي أن ننجح فيها وأن نهزم مخططات الاحتلال التقسيمية والتوسعية. أما الملف الثالث وهو ملف طبيعة المقاومة، وتشكيل جبهة موحّدة لإدارتها، فهو الموضوع الأسهل والأكثر قرباً للتنفيذ على أرض الواقع، طالما تم الاتفاق على الحد الأدنى وهو المقاومة الشعبية السلمية، من دون أن يمنع ذلك فصائل المقاومة المسلحة من أن تواصل أداء دورها في ظل تمادي العدوان الإسرائيلي وحصاره لقطاع غزة.
ثمة إقرار من قبل الكل على مبدأ التمايز بين الظروف السائدة في الضفة، عن مثيلاتها في غزة، وأن أشكال المقاومة الممكنة في غزة قد لا تكون مناسبة في هذه المرحلة بالذات.
إن قراءة الخطابات التي ألقيت في الاجتماع، تنطوي على قناعة مستبطنة، رغم أن البعض أعلن عنها، من أن التطورات السياسية، لم تعد تسمح بأن يكون المشروع الوطني محصوراً في الحقوق التي ترتبها الشرعية الدولية للفلسطينيين على الأراضي المحتلة العام 1967، التي تلتهمها التوسعية الإسرائيلية.
وكما قال أحدهم فإن الأمر مختلف هذه المرة حيث من غير المسموح الفشل، فإمّا أن ننجح أو ننجح.