
نحو انخراط المثقفين في المعركة
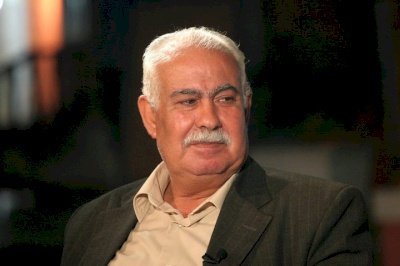
تعمّدتُ أن أكتب هذا المقال، قبل الاجتماع العادي لوزراء الخارجية العرب، الذي تنظمه الجامعة العربية، وتعمّدتُ، أيضاً، أن لا أتابع أي أخبار تتصل بالمساومات التي جرت قبل الاجتماع، بشأن الموقف والبيان الختامي، ومع أننا كفلسطينيين كنا دائماً نطالب وندعم بقاء وفاعلية الجامعة الا انها دائماً كانت جامعة الحد الأدنى غير الملزمة، وقد عُرفت تاريخياً بجامعة البيانات النظرية، التي قلّما يخرج أفعال عنها تلبي تطلعات الأمة العربية، وتحمي مصالحها وأمنها القومي الجماعي.
العيب طبعاً ليس في الجامعة كمؤسسة، ولا في ميثاقها الذي يجري تجاهله، فالعيب في مكوناتها، وسياسات حكوماتها وأنظمتها السياسية. بصمات المستعمر، الذي قسم المنطقة وأنشأ الكثير من كياناتها السياسية، لا تزال موجودة بقوة، حتى في السياسات الداخلية للكثير من الكيانات والأنظمة. وحتى ننصف التاريخ، فإن الجامعة في زمن مضى كانت قد لعبت دوراً مهماً في عديد المحطات السياسية وإزاء عديد التطورات، خصوصاً التي تتصل بفلسطين وقضيتها وقضايا الصراع العربي الصهيوني.
منذ توقيع اتفاقيات «كامب ديفيد» وما تلاها من اتفاقيات، انهارت الجامعة، وانهار الإجماع العربي، ما قدم لأصحاب النفوس الضعيفة، والمصالح الأنانية، المبرر لما تشهده الساحة العربية هذه الأيام. هذا يعني أن ثمة سياقا طويلا، ومقدمات كبيرة لحالة الانهيار، والبحث عن السلامة الوطنية. في زمن قيل إنه زمن «الربيع العربي». كان يمكن أن تكون الاحتجاجات الشعبية التي سادت عديد المجتمعات العربية منذ نهاية 2010 بداية لعصر جديد، لكن المخططات الأميركية الصهيونية، كانت حاضرة بقوة شديدة كل الوقت، وتستخدم كل الأدوات المتاحة لإعادة بناء كل شيء في المنطقة بما يخدم تعميق هيمنتها وتوسيع نفوذها الاستعماري، وإخضاع الجهلة الذين يرون فيها المنقذ والحامي.
قد تخضع الانظمة الحاكمة، لمغريات الحماية الأميركية الإسرائيلية الموهومة، ولكن من الغريب أن تخضع بعض العقول المحسوبة على الثقافة، لكن هذا ليس غريباً على الواقع، فثمة من يشكلون جزءاً من الفكر السائد على مستوى الحكم، فيكونون أقرب إلى كاتب السلطان، لكنهم في دفاعاتهم عن السلطان، يبالغون حتى لا يجدوا من يبتلع أكاذيبهم وادعاءاتهم.
كان لنا صديق قد أصبح في ذمة الله، يحرص كل الوقت على ادعاء أن قريته المحتلة، كانت قمة التطور والتحضر والعلم، فيها مسجد ومدرسة، وإليها يسافر التلاميذ من قرى بعيدة، يحصل هذا حين لا يكون هناك أحد من كبار السنّ، الذين عاشوا تلك الفترة.
في إحدى المرات، وفي حضور عدد كبير نسبياً من الضيوف المدعوين على غداء ينظمه أحد شخصيات قريته احتفالاً بأخيه الذي يكبره سنّاً، استعاد صديقنا معزوفته المعهودة، وكانت مثل هذه الأحاديث، تدور حين يجتمع عدد من قرى مختلفة وذلك في اطار التسلية والمناكفات المحببة. أحدهم طلب شهادة الضيف القادم من الأرض المحتلة، حين كنا في دمشق قبل «أوسلو»، فقال: إن هذا الكلام غير صحيح، وان ابناء القرية كانوا يذهبون الى قرى مجاورة لتلقي العلم والدراسة. غضب صاحبنا، فقال : لعنة الله عليكم فأنا أحاول أن أصنع لكم تاريخاً، وأنتم ترفضون.
كان ذلك من باب المزاح وخفّة الرُّوح، لكننا في هذه الأيام، نسمع روايات غريبة عجيبة، عن تواريخ وأحداث وأصول، لم تظهر قبل موجة التطبيع الأخيرة. ينبري البعض، لروايات تاريخية تجعل اصل الحضارة والتقدم في هذا البلد او ذاك حتى ينقلب المستمع على ظهره ضحكاً، أو بكاءً إزاء ما وصل إليه الحال.
ولفرط المبالغة بالاختراعات والأكاذيب، فليفعل هؤلاء المتثاقفون ما يشاؤون في ما يتعلق ببلادهم، فليس للكلام أي ثمن في هذا الزمن، ولكن، فلينتبهوا جيداً، وليس من حقهم أن يُزوِّروا التاريخ، إزاء الأصول والروايات التاريخية للآخرين. لا يمكن لمثل هذا الفعل أن يبرر سياسات الحكام والحكومات، في تزيين تاريخ اليهود والصهيونية، وتزييف الرواية الفلسطينية والعربية.
الفلسطينيون لم يبيعوا ارضهم، ولم ولن يسلّموا بحقوقهم، والإسرائيليون ليسوا من طينة المنطقة، ولا من مكوناتها، وأبناء هذا الجيل يعرفون تماماً ان اليهود قدموا إلى فلسطين في إطار مخطط استعماري، وأن الحركة الصهيونية ارتكبت الكثير من الفظائع، وقدمت الكثير من الإغراءات، لاستقدام اليهود إلى فلسطين.
الكل يعرف من أبناء هذا الجيل أن اليهود من أصول عربية كانوا يحظون بكل الرعاية والتسامح من قبل جيرانهم المسلمين والمسيحيين، وأن بعضهم يتوق إلى العودة، ويتذكر جيرانه ومدرسته وكنيسه، لكن ظروف المنطقة لا تسمح بذلك.
أيها المثقفون والمتثاقفون، لقد سقطتم، أما الصهاينة وحدهم، فإنهم يحتفلون، فلقد ظهر من بين «أعدائهم»، من يرد بالتزوير على ما استنتجه المؤرخون الجدد، من العلماء اليهود، الذين فنّدوا مزاعم الصهيونية، ورفضوا التزوير في رواية التاريخ.
على قلة هؤلاء، إلاّ أنهم كالبعوض، الذي يهاجم الإنسان في الليل، فيعكّر صفو هدوئه ومنامه، ولا نظنهم سيشكلون ظاهرة يعتدّ بها، وتقدم ما يقنع الجماهير العربية على غير ما نشؤوا وتثقفوا عليه.
في مصر، ورغم مرور عشرات السنوات على توقيع «كامب ديفيد» إلاّ أن قطاع الثقافة والإعلام، ظل يرفض ويقاوم التطبيع المجتمعي والثقافي وقد ظلت إسرائيل تشكو هذا الأمر، وتتحدث عن سلام بارد.
من لا يصدّق ذلك عليه أن يعود لمشاهدة العديد من الأفلام والمسلسلات، والمسرحيات، وشتّى الفنون، والروايات والشعر، ليتأكد أن قطاع الثقافة لم يحد عن روايته التاريخية. تابعوا الإعلام المصري بكل أنواعه، ودقّقوا في المفردات، والمضامين، لتتأكدوا أن الثقافة العربية متجذّرة، في رفضها للاستعمار، وربيبته إسرائيل، التي شبّت عن الطَّوْق، وتمارس اليوم دور المستعمر، بكل خصائصه، ومخرجاته، وآليات تحقيق أهدافه.
ما نرى ونسمع يثير السخرية، خصوصاً حين يصدر عن بعض المتثاقفين أو الأئمة، ورجال الدين، الذين قبل قليل من الوقت، كانوا يتحدثون عن الاستعمار والصهيونية بلغة ومضامين، وكيف انقلبوا على ما كانوا يفعلون، وما كانوا يقتنعون به، بين ليلةٍ وضُحاها.
وبرأينا أن التاريخ لن يمهل هؤلاء كثيراً من الوقت، فإن لم يسعفهم العمر، فإن أبناءهم وجيرانهم ومريديهم، سيكتشفون، المصيبة التي أوقعوا أنفسهم بها، حين يتبينوا الأهداف الاستعمارية الخبيثة التي تقف وراء هذا الاستعمار الأميركي الإسرائيلي، واي خراب يصيب أي مكان يطأه في هذه المنطقة.
في مثل هذه الظروف من المناسب أن تنهض جبهة الثقافة العربية الحقة، بمسؤولياتها في مجابهة هذه الظواهر الغريبة على محدوديتها، ومحدودية تأثيرها.