
عام التطبيع وضرورة التصدّي له
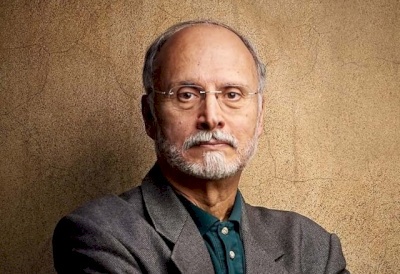
أشرفت سنة 2020 على نهايتها وقد شهدت من المصائب العالمية، لاسيما جائحة كوفيد-19، والمحلّية، كانفجار مرفأ بيروت على سبيل المثال، ما يكفل لها مكانة مرموقة بوصفها سنة مشؤومة في ذاكرة معظم البشر. أما مؤرخو سياسة إسرائيل الخارجية فسوف يتذكرون سنة 2020 بوصفها سنة التطبيع، أي السنة التي حققت فيها الدولة الصهيونية أكبر الانجازات في الهجوم المضاد الذي شنّته حكومة بنيامين نتنياهو منذ أعوام على حملة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات». وقد جاء هذا الهجوم بعد أن أخذت حملة المقاطعة تحقق النجاح تلو النجاح في جعل المؤسسات الجامعية والنقابية، على وجه الخصوص، تتبنى مقترحاتها في شتى البلدان، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية بالذات.
فمنذ سنوات أدركت حكومة نتنياهو مدى الخطر الذي تشكّله حملة المقاطعة على المشروع الصهيوني، فجنّدت أجهزتها وشبكة عملائها وأنصارها في العالم كي تحاصر الحملة وتفكّك منجزاتها، بل وتحظّرها. وقد وظّفت في خدمة هذه الغاية حجتها الأيديولوجية المعهودة، وهي حجتها الوحيدة لكنها حجة قوية للغاية، ألا وهي تذكير الغرب بجريمة الإبادة الهائلة التي ذهب ضحيتها ملايين اليهود الأوروبيين، وهي جريمة يتحمل الغربيون مسؤوليتها بين مقترف ومتواطئ ومتفرّج. فلم ينفك الصهاينة يبتزون الدول والمجتمعات الغربية باستغلالهم لذكرى الإبادة النازية، متعمدين إغفال قسط المسؤولية الذي تتحمله الحركة الصهيونية نفسها في تلك الإبادة من خلال تعاونها مع النازيين حتى الحرب العالمية الثانية ورفضها لمطالبة بريطانيا وأمريكا بإيواء اليهود الهاربين من النازية بغية إبقاء فلسطين ملجأً وحيداً لهم.
كان ذلك بوحي الفلسفة الصهيونية التي لخّصها دافيد بن غوريون عندما أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 1938، بعد أول مذبحة شهيرة ارتكبها النازيون إزاء اليهود في ألمانيا وهي المعروفة باسم «ليلة الكريستال»: «لو كنت أعرف أنه يمكن إنقاذ جميع الأطفال اليهود في ألمانيا بنقلهم إلى إنكلترا، بينما لا يمكن إنقاذ سوى نصفهم بنقلهم إلى فلسطين، لاخترت الخيار الثاني» (نقلاً عن المؤرخ الإسرائيلي توم سيغيف في كتابه المليون السابع).
هذا وقد صعّدت الحركة الصهيونية استغلالها لمسألة «معاداة السامية» لاسيما باستخدامها للتعريف الرديء الذي تبنّاه «التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست» قبل أربع سنوات، وبشنّها لهجوم حامٍ في كافة البلدان الغربية من أجل حثّ الحكومات والبرلمانات والمؤسسات الثقافية والجامعات على تبنّيه بدورها بما يحرّم نقد الصهيونية ودولتها ويجرّمه (نشرت «القدس العربي» بيان المثقفين العرب والفلسطينيين حول التعريف المذكور واستخداماته قبل شهر بتاريخ 30/11). غير أن أعظم مكسب حصلت عليه الحركة الصهيونية في هجومها المضاد على حركة المقاطعة إنما أهدتها إياه إدارة دونالد ترامب، وقد قام صهر الرئيس الصهيوني اليهودي، جاريد كوشنر، ووزير خارجيته الصهيوني المسيحي، مايك بومبيو، بدور بارز في هذا الصدد.
فمع إدراكهم بأنهم قد يفقدون قريباً مقاليد السلطة الأمريكية، بذل فريق ترامب الصهيوني جهوداً محمومة في الأشهر الأخيرة من أجل معاكسة مقاطعة إسرائيل بتفكيك حلقات جديدة من الطوق العربي الرسمي المفروض عليها، وهو الطوق الذي حال حتى الآن دون إنجاز جديد يُذكر منذ أن أقامت مصر السادات علاقات دبلوماسية رسمية مع الدولة الصهيونية في عام 1979 وتبعتها المملكة الهاشمية الأردنية بعد خمس عشرة سنة، في عام 1994، في أعقاب الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية من خلال اتفاقيات أوسلو-واشنطن.
وقد رأى العالم في مشهد غير مألوف إدارة أمريكية تكرّس جهوداً مسعورة في خدمة دولة إسرائيل في أشهرها الأخيرة، إذ لم يتوانَ فريق ترامب في تقديم شتى ما في جعبة أمريكا لقاء الحصول على قرارات التطبيع العربية. وقد حققوا منها أربعة، فبعد وعد الإمارات العربية المتحدة ببيعها طائرات ف-35 لقاء مسرحية «اتفاقيات أبراهام» التي اعترفت من خلالها رسمياً هي ومملكة البحرين بالدولة الصهيونية، جاء دور السودان الذي ابتزت واشنطن حكمه العسكري بإزالة اسم البلد من قائمة الإرهاب (التي تخوّل نفسها بها الدولة الأمريكية الإرهابية بامتياز صلاحية تعيين من تراه هي إرهابياً) وبعده المملكة المغربية التي أغراها فريق ترامب باعتراف واشنطن بمغربية الصحراء الغربية، الأمر الذي أثار حفيظة بعض أركان السياسة الخارجية الأمريكية بين الجمهوريين أنفسهم، كجيمس بيكر وجون بولتون. وقد بلغ بذلك عدد الحكومات الأعضاء في جامعة الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الدولة الصهيونية سبع حكومات (بما فيها موريتانيا التي أقامت علاقاتها في عام 1999) من أصل اثنتي وعشرين.
فلا بدّ لحركة المقاطعة في البلدان العربية وكل الحركات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني والمناصرة لقضيته أن تصعّد جهودها هي بدورها في العام الجديد من أجل الحؤول دون المزيد من الطعن في ظهر الشعب الفلسطيني. ومن أجل ذلك لا تكفي مناشدة الدول الأخرى كي لا تحذو حذو الحكومات السبع، بل ينبغي العمل من أجل حث هذه الحكومات السبع ذاتها على قطع علاقاتها بالدولة الصهيونية (أو عدم المضي قدماً في إقامة هذه العلاقات). ولا بدّ في هذا السبيل من أن تقدم حكومة «السلطة الوطنية» الفلسطينية المثال، إذ تتحجج الحكومات الأخرى بالعلاقات القائمة بينها هي والدولة الصهيونية. والحال أن «السلطة» فعلت عكس المطلوب في استعجالها إلى إعادة التعاون مع المحتل الصهيوني، ظناً منها أن ذلك سوف يلمّع صورتها لدى فريق الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن. هذا وينبغي على الحركات الشعبية في المنطقة العربية أن تواصل احتجاجها على تمثيل الدولة الصهيونية في بلدانها كي تبقى كلفة استضافة سفارات إسرائيلية في بلدان عربية أكبر مما تتوخى حكومات هذه البلدان الحصول عليه من خلال التطبيع.