
ديمقراطية منقوصة
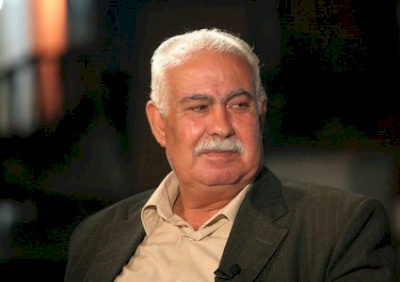
يحتار أعظم المفكرين والفلاسفة، والسياسيين، والمثقفين في قراءة الحالة الفلسطينية، ولا يجد أي من هؤلاء مناهج قياس علمي أو قانوني أو حتى تاريخي، يمكن الاعتماد عليها لإنجاز قراءة صحيحة يمكن البناء عليها.
الحالة ذات خصوصية متفردة، وتنطوي على تعقيدات هائلة، فالشعب والأرض والحقوق الفلسطينية تتعرض لنوع فريد من الاستعمار الذي يعتمد على رواية مفبركة، لا ترى في هذه الأرض شعباً وكأنها مهجورة لم يطأها إنسان.
وتمتد الفبركة إلى أن هذه الأرض هي وعد الرب لليهود، وفضلاً عن ذلك، فإن كل ذلك ينتظم في سياق مشروع استعماري دولي.
جزء بل الجزء الأكبر من أرض فلسطين التاريخية تحت الاحتلال، وتحت سلطة دولة إسرائيل وفيها يعيش 20% من المواطنين هم أصحاب الأرض الأصليون.
في القسم الأصغر من الأرض، أي في الضفة وغزة والقدس يعيش جزء آخر من أصحاب الأرض، يقارب عددهم الملايين الخمسة ولكن اسرائيل تسعى لتهجير هؤلاء، ومصادرة أرضهم بالاستيطان والقمع حتى يتحقق لها الحلم الأكبر في السيطرة على كل الأرض.
مشكلتهم أن الفلسطينيين شعب يصل تعداده إلى أكثر من ثلاثة عشر مليون إنسان نصفهم في الداخل، والنصف الآخر في الخارج لكن أهل الخارج كما أهل الداخل، متمسكون بحقوقهم التاريخية، ويقاومون الوجود والرواية الصهيونية، ويملكون عناداً وحيوية تفيض عن قدرة اسرائيل على إنكار وجودهم.
لا يكف الإسرائيليون عن التعبير عن مخاوفهم الوجودية، وثمة من يتجرأ بين الوقت والآخر للحديث عن العمر الافتراضي لدولة إسرائيل.
مقابل هذا الشعور بالخوف، رغم ما تمتلك إسرائيل من وسائل الدمار الشامل، والدعم اللامحدود من القوى الاستعمارية، مقابل ذلك نراهن على أنه لا يوجد فلسطيني واحد، غير مقتنع بحق الشعب الفلسطيني في كامل أرضه، وأنه سيستعيد حقوقه يوماً ما.
قبول بعض التيارات الفلسطينية بالحل السياسي على أساس إقامة الدولة على الأراضي المحتلة العام 1967 بما في ذلك القدس أي على 22% من أرض فلسطين، ليس سوى قبول سياسي تفرضه طبيعة موازين القوى بمعناها الشامل ومحاولة لتأكيد الحقوق السياسية على جغرافيا فلسطين حتى ولو على جزء منها.
إسرائيل تدرك ذلك تماماً، ولذلك فإنها تفعل كل شيء ممكن لمنع ذلك، لأنها تدرك أن قيام دولة فلسطين على جزء من الأرض يشكل المسمار الأهم في نعش المشروع الصهيوني.
ثمة التباسات كثيرة ومعقدة، تنعكس على الحالة الفلسطينية بسبب هذه الفرادة في تصادم المشاريع والأهداف، فهي تبدو كأنها غادرت مربع التحرر الوطني، ولكنها في الوقت ذاته، لم تنجح في إقامة الدولة التي سيحكم وجودها اشتراطات موضوعية.
هذا المشهد بدوره ينطوي على مفارقات، فثمة من يتمسك بالرؤية التي تقول إن المرحلة هي مرحلة تحرر وطني، ويناضل من أجل إعادة بناء المؤسسة الوطنية العامة على هذا الأساس.
طرف آخر يتحدث عن السلطة كدولة افتراضية، ويدير السياسة على هذا الأساس، وبالتالي فإنه يحاول تلبية استحقاقات دولية وإقليمية، لا تتعاكس مع تطلعات فلسطينية واقعية.
هكذا يمكن رؤية الانتخابات الفلسطينية، فهي من ناحية تشكل استجابة لمتطلبات ملاقاة الجهد الدولي الذي يسعى لإحياء العملية السياسية، ومن الناحية الأخرى تشكل استجابة لمتطلبات وضع فلسطيني يحتاج إلى استعادة الوحدة وبناء الشراكة الوطنية، بما يؤدي إلى تقوية الأوضاع الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.
طرف من الفلسطينيين يريد من الانتخابات إعادة بناء الشرعية، وضبط التوازنات الداخلية بما لا يحدث انقلاباً على من يقود السفينة الفلسطينية، وطرف آخر يريدها لإنهاء الانقسام، والدخول في النظام السياسي، والنضال من داخله، وأيضاً الحصول على الشرعية.
في ضوء ذلك تنشأ الشكوك لدى الكثيرين بشأن إمكانية تنفيذ المراسيم الرئاسية في مواعيدها، إن كانت ستؤدي إلى تغيير أو انقلاب في المشهد السياسي العام، أو يهز سلطة القرار، التي يرغب المحيط الإقليمي والدولي في التعاطي معها.
في كل الأحوال فإن الانتخابات لو أنها جرت بكامل مفاصلها وفي المواعيد المحددة، فإنها لا تمنح الفلسطينيين الشعور بأنهم يعيشون في ظل نظام ديمقراطي.
الانتخابات حالة ديمقراطية فوقية لا تعكس ديمقراطية مجتمعية فالحق في اختيار الممثلين، ليس حصراً فقط في اختيار مجلس تشريعي ورئيس ومجلس وطني.
المجتمع يتوزع على فئات مهنية شديدة التنوع، ولكل مواطن الحق في أن يختار ممثليه الذي يعبرون عن مصالحه ويناضلون من أجلها، وهكذا يمكن أن تخدم الديمقراطية في تحسين أحوال وحقوق المواطن.
في هذا الصدد أيضاً، يلفت النظر أن الفصائلية تتخذ طابع القبلية السياسية غير البعيدة عن المنفعية. غريب أن يصل عدد الفصائل إلى ثلاثة عشر، عدا جماعات أخرى كثيرة، لم تحز على شرعية الاعتراف من قبل الفصائل التاريخية.
في الواقع ثمة تشابه كبير وواسع، في البرامج السياسية لدى عديد الفصائل لكن المنفعية تمنع اندماج بعضها في فصائل أخرى.
ينشأ عن ذلك حالة من الجمود من المشهد الحزبي والفصائلي، ويصبح ذلك جزءاً من لعبة السياسات والسيطرة ليس أكثر.
نتمنى أن لا تمنع الانتخابات المواطن من أن يقرر عبر صناديق الاقتراع، من عليه أن يبقى ومن عليه أن يغادر الساحة السياسية، ويبحث له عن انتماء جديد.
حتى لو كان النظام الانتخابي يسمح بإنشاء تحالفات، فإن استعمال هذا الحق، للمحافظة على وجود فصائل، لا يشكل غيابها فرقاً عن وجودها إنما يشكل مساساً بجوهر الديمقراطية، وينزع من المواطن جزءا من حقه، فضلاً عن أنه يشكل استمراراً للعبة السياسية ذاتها.