
السياسة أوّلاً
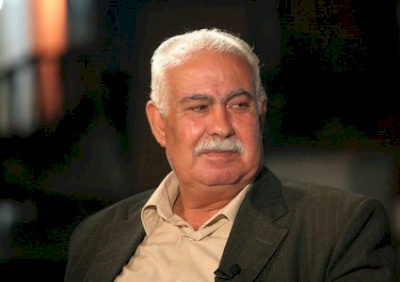
بخلاف من طبيعة الأشياء، فبدلاً من أن تظهر على المجتمع مؤشرات الرضا والاحتفال، يسود القلق والضياع وعدم الاكتراث إزاء كل ما يتصل بملف الانتخابات والمصالحة، وإمكانية تغيير واقع الحال. الانتخابات حسب القوانين، وحين تتوفر إرادة الالتزام بمواعيد وآليات إجرائها، تكون مؤشراً قوياً على سلامة العلاقة، والالتزام بالعقد الاجتماعي بين المواطن ومؤسساته الوطنية التمثيلية، لكنها في الحالة الفلسطينية وبعد خمسة عشر عاماً على الانتخابات السابقة، تصبح مؤشراً على فقدان الثقة بالقوانين، التي لا يتوقف الجميع عن الإعلان نظرياً عن التزامه بها.
بالرغم من تتابع الحوارات الثنائية، والوطنية الجامعة، ومن استعداد الجميع للالتحاق بروح إيجابية متفائلة، بمحطة الحوار القادم في القاهرة، إلاّ أن ثمة من لا يزال يرفع علامة الشك حول إمكانية إجراء الانتخابات في مواعيدها.
المشككون لا يستندون إلى معلومات، وإنما على تحليل المؤشرات، ففي الحالة الفلسطينية تعود الناس، على سياسة الغموض، والتناقض بين المعلن والمضمر، وإزاء هذه الانتخابات، لا يمكن أن نسمع صوتاً يطالب بتأجيل الانتخابات، ولكن ذلك لا يعني أن إجراءها أمر مؤكد.
يسوق هؤلاء جملة من المؤشرات، من بينها جملة القرارات والمراسيم التي صدرت، وأدت إلى استفزاز قطاعات وفئات واسعة، فمثلاً توقع أكثر من مئة وعشرين مؤسسة مجتمعية على بيان يطالب بإلغاء التعديلات على قانون الجمعيات الأهلية.
في الواقع، فإن من ينتظر إجراء الانتخابات، ويأمل بالفوز فيها، يتعمد إلى اتخاذ إجراءات، تستقطب اهتمام الناخبين، وتعدهم بالأفضل في حال مارسوا حقهم الانتخابي. أما ما يجري فإنه يعاكس طبيعة الأمور. وبصرف النظر عن إمكانية إجراء الانتخابات بعضها أو جميعها في المواعيد التي حددها المرسوم الرئاسي، أو تأجيلها فإن المسألة تتعلق بالحاجة لتغيير الواقع القائم الذي يشكو منه الجميع، الفصائل ومنظمات المجتمع المدني، وأيضا النشطاء والمواطنون.
أراهن على أن الناخب الفلسطيني عموماً، كان قد قرر، ما يفعله في حال جرت الانتخابات، فخلال خمسة عشر عاماً من الانقسام، والفشل، والفقر، والمرض، والحصار، والقمع للحريات، يكون المواطن قد انحاز إلى التجربة الملموسة، وليس إلى ما يمكن أن يُقال خلال الحملات الانتخابية. بعض المتسابقين على الترشح للمجلس التشريعي، إن كانوا أفراداً، أم فصائل، أخذ يصدر خطاباً، يلامس مصالح المواطن المعيشية والاجتماعية والصحية، اعتقاداً منه أن ذلك، سيكون سبباً لاستقطاب الأصوات.
بعد أن فقد الكلام مصداقيته، لم يعد المواطن يصدق ما يُقال من معسول الكلام والوعود البرّاقة، فلو أن الأمر يتصل بالخطابات والوعود لكانت فلسطين تحررت من بحرها إلى نهرها، ولذلك فإن المواطن لا يصدق إلاّ ما تلمسه حواسه الخمس بكاملها.
مع ذلك، فإن قوائم المترشحين، سواء كانوا فصائل، متحالفة أو منفردة أو كانوا مستقلين، إنما يتحملون مسؤولية وطنية، وتاريخية إزاء الأولويات، وعلى رأسها البرنامج السياسي.
البرنامج السياسي، هو الأساس، والجذر الذي ترتبط به، كل الملفات التي تهم الوطن والمواطن. في الواقع فإن اتفاق الفصائل في القاهرة على مرجعية وثيقة الوفاق الوطني لعام 2006، فضلاً عن أن تلك الوثيقة ستظل للتاريخ بعد خمسة عشر عاماً على إقرارها. فخلال الخمسة عشر عاماً، جرت مياه كثيرة في النهر، وخلالها لم يلتزم أحد، بما ورد في تلك الوثيقة لا بشكل جماعي ولا فردي أو فئوي.
الحديث عن البرنامج السياسي، يتطلب مراجعة عميقة لما جرى، ولتحديد أسباب وطبيعة الفشل، الذي يشمل كل المشاريع السياسية المطروحة في السوق، لا بل إن المراجعة ينبغي أن تمتد في عمق الزمن لتقييم طبيعة المرحلة السابقة منذ اكثر من نصف قرن، جرى خلالها تدمير المشروع الوطني، وتدمير عناصر القوة الفلسطينية مقابل تقدم مطرد للمشروع الصهيوني.
إذا امتنع عن ذكر الأسماء حتى لا يحسب ذلك على دعاية انتخابية مبكرة لبعض الشخصيات، فلقد أعجبني ما قاله أحدهم ممن يحسبهم البعض على التيار الليبرالي، وربما يتهمهم البعض بموالاة السياسة الأميركية.
قال ذلك الإنسان المحترم، إنه ليس على الفلسطينيين أن يراهنوا على إدارة بايدن والسياسة الأميركية، فإن كان بايدن جاداً فإن عليه أن يصحح سياسات وقرارات ترامب وابتداءً من إلغاء قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها. وفي ظل هيمنة سياسة ومنهج البحث عن السلام من خلال المفاوضات ومرجعية القرارات الدولية، يقول، إنه حان الوقت لتذكير العالم، بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني على كل أرضه.
في الأول والأخير، فإن لقاءات الفصائل، حول أي وثيقة سياسية لا تضمن ولا تعني أن تغييراً سيقع على المستوى السياسي، وأن كل طرف سيمارس السياسة التي يراها مناسبة.
الاتفاق السياسي يبدو شكلانياً إلى حد كبير، فالكل يرغب في ألا يتحمل المسؤولية عن تعطيل الاتفاق بشأن الانتخابات، ولكن المشهد السياسي العام من غير المحتمل أن يشهد تغييراً على مستوى الرؤى السياسية.
وإذا كان تجاوز الخلاف السياسي، أمرا تفرضه الوقائع، ومتطلبات إجراء تغييرات تكتيكية أو جزئية على واقع الحال، فإن ذلك لا يضمن لا إنهاء الانقسام ومؤسساته، ولا النهوض بمنظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بنائها، ولا بطبيعة الحال تغيير واقع المجتمع ومعانياته إلاّ بحدود بسيطة لا تلبي الحاجة. سيكتشف الفلسطينيون، إن لم يكونوا اكتشفوا، أن الانتخابات ليست المدخل الصحيح لإجراء التغيير اللازم على مختلف المستويات والأطر، وأنها قد تكون مدخلاً لتكريس الانقسام والاتفاق على إدارته.