
"مكياجات" لا تُغيّر الحقائق
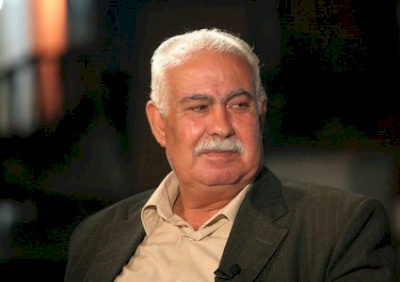
ثقيلة التركة التي ورثها الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته عن الإدارة السابقة، التي عبثت باستراتيجيات وسياسات الولايات المتحدة في مختلف أنحاء الكرة الأرضية.
مع هذه التركة الصعبة، والتي تبدأ من الظروف الاجتماعية والسياسية الداخلية، والانقسامات التي خلقها ترامب ومريدوه، وتنامي العنف والتحريض والعنصرية، تجد الإدارة الجديدة نفسها في حالة من الارتباك.
إن كان الأمر يتصل بما تركه خطاب ترامب المجتمعي من آثار سلبية وخطيرة، فإن الأوضاع والصعوبات الداخلية لا تقتصر على هذا الملف، إذ تتفاعل معه بقوة، الآثار المترتبة عن جائحة كوفيد، على الأوضاع الاقتصادية بما يثقل على خزينة الدولة وعلى الأحوال المعيشية للمواطنين.
على المستوى الخارجي حدّث ولا حرج، إذ يترتب على الإدارة الجديدة، مراجعة السياسات التي اعتمدتها الإدارة السابقة، لتنظيف سمعة الدولة الأعظم حتى الآن، وأدخلتها في عراك مع حلفائها التاريخيين وعراك لا يتوقف مع إيران، والصين، وروسيا، والأمم المتحدة، فضلاً عن ملفات عامة مثل اتفاقية المناخ.
الشرق الأوسط لم يكن خارج دائرة الهجوم الترامبي، حتى لا نقول عراكاً لأن أحداً في هذه المنطقة باستثناء إيران ومن يحسب عليها، لم يخض عراكاً حقيقياً.
الفلسطينيون وقضيتهم وحقوقهم كانوا من أبرز ضحايا السياسة الترامبية، وبالرغم من أنهم رفضوا بقوة تلك السياسات، إلا ان واقع الحال لا يشير إلى أن الفلسطينيين قد دخلوا في عراك حقيقي مع الإدارة السابقة، وانهم لم يتمكنوا من تعطيلها.
إدارة بايدن تجد نفسها مضطرة للتعامل مع كل هذه الملفات والتعقيدات، ولكن دون وضوح في الأولويات فمرة يقال ان الملف الداخلي هو الذي يقع في رأس جدول الأولويات ومرة يُقال إيران، وفي مرات أخرى، تصبح الصين هي العدو الأول للولايات المتحدة.
الملف الفلسطيني الإسرائيلي واحد من هذه الملفات المعقدة ولكن يبدو أنه لا يقع بعد ضمن جدول الاهتمامات الأساسية السياسية.
في انتظار تحرك أميركي جدي لتنشيط ملف المفاوضات التي تتصل بعملية التسوية، تصدر الإدارة الأميركية مجرد إشارات لا يمكن تجاهل أهميتها، لكنها تبدو وكأنها إجراءات أولية أو إشارات عملية تحضيراً لمرحلة لاحقة ذات أبعاد سياسية.
الإدارة الأميركية، أكدت غير مرة أنها ملتزمة بتحقيق السلام على أساس رؤية الدولتين، وباستعادة العلاقات مع الفلسطينيين، والعودة لتقديم الدعم المادي الإنساني.
جيد أن تعود الولايات المتحدة لدفع جزء من التزاماتها تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ولكن المئة وخمسين مليون دولار التي قررت تقديمها لـ»الأونروا»، هي أقل من نصف المبلغ الذي كانت الإدارات السابقة على إدارة ترامب تدفعها لهذه المؤسسة الدولية.
المساعدات الأخرى، سواء للسلطة أو منظمات المجتمع المدني، أو الأمن ومستشفيات القدس، لا تزال تقدم بالتدريج، وكأنها مرتبطة بشروط معينة لا تعلن عنها الإدارة الأميركية حتى الآن.
صحيح أن الإدارة عادت للانفتاح على السلطة، عبر الاتصالات، ولكن لم تتخذ بعد خطوات عملية فيما يتعلق بمكتب المنظمة في واشنطن وإزاء موضوع القدس، حتى بحدود استعادة دور القنصلية الأميركية.
وجيد أيضا أن تعود الولايات المتحدة للتعامل مع الضفة الغربية والجولان على اعتبار أنها أراضٍ محتلة بما يعني انها تعود لسياساتها التقليدية، وما صدر عنها من قرارات، ولكن هذه العودة، لا تعني بالضرورة، فعلاً أميركياً جديداً ومختلفاً عن السياسة التي دأبت عليها قبل بايدن.
كل ذلك لا يؤشر على إمكانية المراهنة على دور أميركي مختلف إزاء ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ ينقص هذه المراهنة جملة من المواقف المطلوبة لتعزيز هذه المراهنة.
الولايات المتحدة، ليست في وارد تغيير موقف الإدارة السابقة من القدس رغم أنها واحدة من القضايا التي صدرت بشأنها قرارات دولية وباعتبارها جزءا من الأراضي المحتلة العام 1967، ولا يمكن استثناؤها من جوهر مطالبات الفلسطينيين، ورؤية الدولتين، إن كان ثمة مجال لذلك.
إدارة بايدن، لم تصدر أي موقف، ولم تمارس حتى الحد الأدنى من الضغط على الحكومة الإسرائيلية بشأن حُمّى الاستيطان التي تزحف على كل الأرض المحتلة.
وهذه الإدارة أيضا، وإن أقدمت على رفع العقوبات التي قررتها إدارة ترامب على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها تتصدى بالباع والذراع، لحماية إسرائيل، وتمكينها من إفشال دور المحكمة من التحقيق في جرائمها.
وإزاء ملف الانتخابات الفلسطينية، ثمة ما يدعو للقلق وحتى الاستنكار، إذ تشارك الولايات المتحدة إسرائيل في الرغبة بعدم إجراء هذه الانتخابات، بالإضافة إلى أنها عادت لطرح شروط الرباعية الدولية على الفصائل التي ستشارك في هذه الانتخابات.
إسرائيل ستقوم بكل الوسائل لتعطيل وإفشال الانتخابات الفلسطينية المقررة ولديها عديد الأوراق، بما في ذلك الاعتقالات الموسعة وموضوع القدس. الغريب في الأمر، ان إدارة الجمهوري جورج بوش الابن، والإدارة الإسرائيلية في عهده، وافقت على مشاركة حركة حماس في انتخابات العام 2006، فلماذا ترفض اليوم، إن لم يكن الأمر له علاقة بحسابات لا تتفق مع الحسابات والمصالح الفلسطينية؟
في مطلق الأحوال، فإن الأمر في الأخير معلق في رقبة الفلسطينيين الذين عليهم أن يرفضوا كما فعلوا أيام ترامب، أي سياسات أو مواقف أو ضغوط، من شأنها أن تعطل الانتخابات باعتبارها مصلحة وطنية فلسطينية مهمة ذلك أن أميركا لم ولن تصبح وسيطاً نزيهاً، ولأن كل ما تفعله هو لمصلحة إسرائيل.